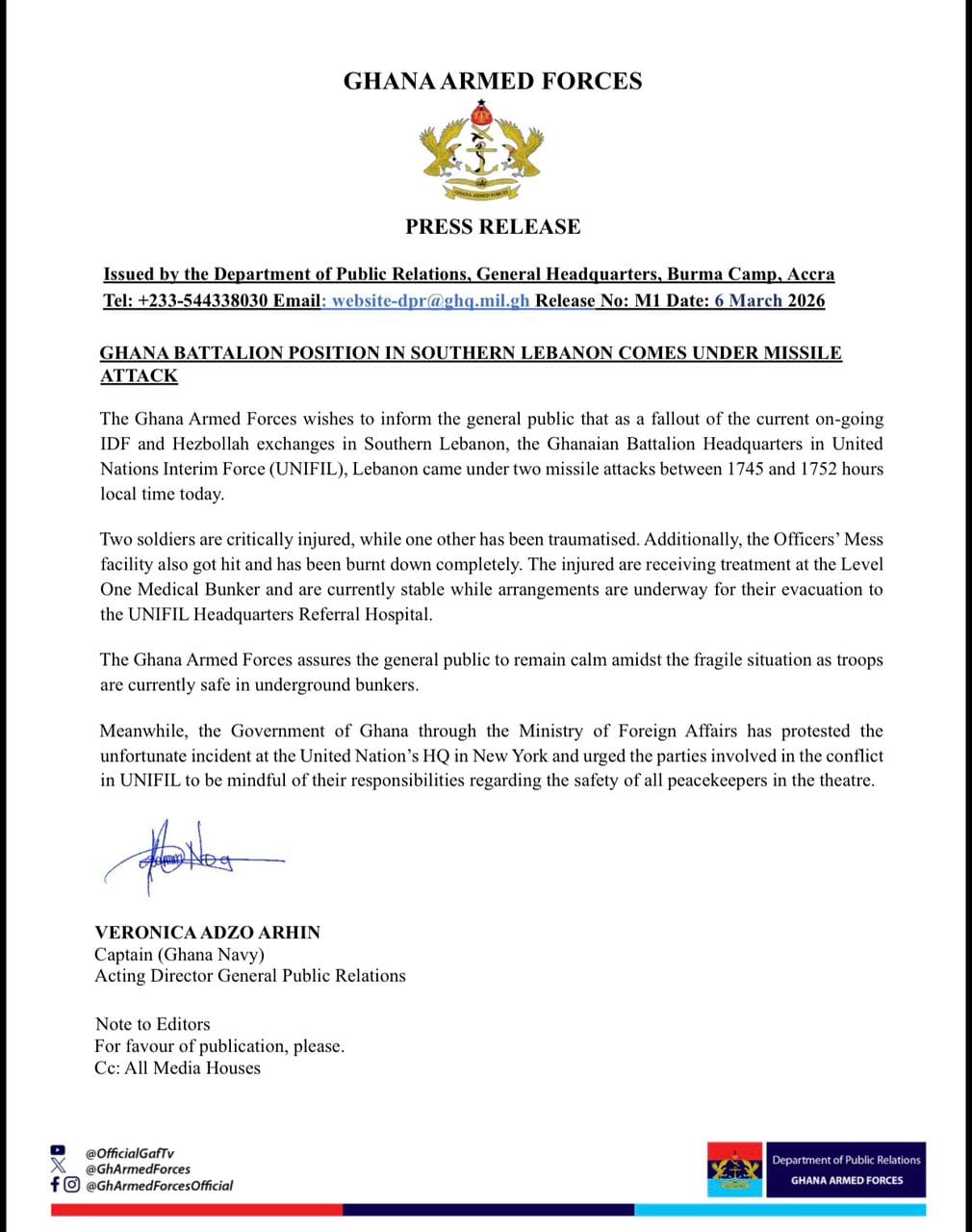أواصل هنا ما كنت بدأته في عدد سابق عن تمنياتي لموريتانيا بمناسبة حلول الألفية الثالثة لميلاد المسيح عليه السلام.
وأبدأ بفكرة مهمة جدا عندي، وهي إنشاء نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، ليس فقط لتدريب الشباب علي استعمال السلاح الناري إذ ليس من الضروري تعلم ذلك لقتل الأقارب، بل لتعليمهم أن عليهم دينا لوطنهم، وتلقينهم حسن الانتماء الي أمة وطنية واحدة.. حسا يفترض ويفرض المساواة والتضامن والإخاء..
وهكذا يتم إرسال طبقة عمرية بكاملها إلي المناطق الداخلية مؤطرة من طرف الدرك أو الحرس من اجل تلقي تربية صحية، حتى ولو من اجل تعليم الناس كيف يغسلون أيديهم أو كيف يستاكون.. علي كل مجموعة من المتدربين أن تتصور مشروعا صغيرا وتنفذه كاملا بالتعاون مع السكان المحليين.
ويمكن ان يكون هذا المشروع من نوع بناء المراحيض التي تكون القرى في الداخل في مسيس الحاجة إليها، أو غرس أشجار الصمغ العربي أو زراعة البطاطا والبصل، أو تعليم الأبناء كيف يجعلون من قريتهم مكانا مريحا وملائما بالأخذ من وقتهم لإنشاء ساحات للعب وحدائق صغيرة وأنشطة للتوعية... يجب أن تستمر هذه الخدمة أقل من تسعة أشهر، وان تدمج من بين أمور أخري في برنامج الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر.
واعتقد أن هذه الخدمة، رغم مدنيتها، يجب أن يتم تأطيرها من قبل الجيش وتكون من بين فقراتها فقرة عسكرية حتى يتعلم هؤلاء الشباب الانضباط والجهد الجماعي، إذ أنهم فليلوا التحمل، فما أن تبزغ شمس التاسعة حتى يلجأوا الي الظل.. كما يفعل حملة الشهادات العاطلين أمام مفوضية حقوق الإنسان.
ومن مزايا هذه الخدمة الوطنية أنه لن تكون هناك حاجة الي البحث كل سنة عن سبب واه لإرسال هؤلاء الشباب الي سجون "ولاته" وكيهيدي وبومديد.. بل يكفي إرسالهم في إطار واجبهم الوطني الي "العكله" لتثبيت اليرخانة، او شق طرق في "أمزماز"، أو تشجير "تازيازت"، أو غرس أشجار "الطلح" في خط مقابل لمدار السرطان.
أريد كذلك، وهذه أمنية أخري، أن نتعلم كيف نفاوض، ولا أعني هنا جلسات التعذيب التي يتعرض لها "مفاوضونا" والتي تجري في واشنطن، حيث يذهبون اليها وكأنهم ذاهبون الي "ماخور"، مع الفرق ان "البنات" في هذه القضية هم نحن الشعوب الخاضعة والخانعة والتي يفرض عليها أن تتفهم وتتقبل كل الأشكال الهزلية للسياسات المالية التي يتصورها فريق من الأغنياء والمختلين..
لا.. أنا لا أعني هذا النوع من المفاوضات، بل أعني تلك الأشياء التي يمكن بالفعل التفاوض بشأنها وعلي رأسها الاتفاقيات المشؤومة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الصيد.. وفي آخرها تلك الأشياء الصغيرة كسباق باريس – أطار – دكار (هكذا أصبحت أسميه) الي غير ذلك من الأمور التي قد تبدو لأول وهلة بلا فائدة إلا أنه يمكن استثمارها، علي الأقل من وجهة نظر إعلامية.
أتمني أيضا، وهذه من اغلي أمنياتي، ان تكون لموريتانيا سياسة إعلامية واضحة تستحق ذلك الاسم، واعرف أنه من اجل وضع هذه السياسة يجب القضاء علي كل عمال وزارة الاتصال وعلى رأسهم الوزير..
ويجب ان لا نترك كل الفرص تمر، وان نعرف كيف نجعل من أنفسنا "صالحين للبيع".. طبعا ليس البيع الذي كنا نتعرض له، أي لمن يدفع اقل، حسب منطق انتحاري لشعب يجري خلف ظله فرارا من ماض لا يريد أن يمضي، وحاضر غائب، ومستقبل له رائحة الماضي المجتر.
أتمني مرة أخري.. وأتمنى.. ويمكن أن أقضي العام بكامله وأنا أتمني.. فهناك الكثير من الأشياء نتمنى لموريتانيا، ومن بينها علي وجه الخصوص قانون عادل للأحوال الشخصية يحمي المرأة والطفل في مجتمع ترتفع فيه معدلات الطلاق، مما يجعل منا امة من أبناء المطلقات تعيش التشتت والضياع، حيث لم تعد الأسرة ملجئا آمنا ولا يوجد ملجؤ بديل عنها.. أو أن نتمنى العثور علي منتجات غير منتهية الصلاحية.. أو تتمني زيادة ساعة في التوقيت علي غرينتش.
أو ان نتمنى افتتاح المدارس في 15 سبتمبر وإغلاقها في 15 يوليو.. از أشياء أخري من هذا القبيل، فالتمني ما يزال مسموحا به.. أليس كذلك؟
هناك أشياء تخيفني في فجر الألفية الثالثة هذه.. ومنها ذلك النزيف الذي يفرغ البلد من شبابه منذ سنوات.. حتى أننا اليوم في مرحلة أصبح عدد الموريتانيين خارج البلاد أكثر منهم داخلها.. وهكذا خلال الخمسين سنة الماضية شهدت البلاد خروجا مكثفا نحو السنغال ومالي ومن ثم الي العربية السعودية والمغرب والكونغو وساحل العاج وغامبيا، ومرة أخري الي السنغال وسيراليون والإمارات ودول الخليج وليبيا والمغرب مجددا، وفرنسا والإمارات مرة أخري، واسبانيا.. وأخيرا الولايات المتحدة.
وكانت لهذه الهجرات أسباب عدة، ففي الأربعينات كانت الهجرات الي السنغال هربا من الجوع والاستعباد.. وكانت المجموعات التي ذهبت الي السعودية (علي ظهور الجمال حتى السودان ومن ثم في قوارب صغيرة) بقصد الحج او المجاورة. ثم تلي ذلك رحلات التجار الي غامبيا وسيراليون.. ثم بعد ذلك شرطة الإمارات.. الخ.
إلا أن ما يخيفني أن هذه الهجرات ليست جديدة كما قد تبدو، بل إنها نتاج للثقافة الشعبية الموريتانية.. فكلنا يعرف مصطلح "الرومدة"، حيث يطوي الجميع أمتعتهم عند حلول فصل الجفاف ويتفرقون بحثا عن الكلأ والمرعي ولا يبقي بمحاذاة البئر المركزية للحي إلا "الرومدة" وهي الخيام الكبيرة والأمتعة الثقيلة.
وعندما ينزل المطر يرجع الكل تقريبا الي الحي المركزي ويتخلف البعض القليل، وهكذا علي مر الزمن يتناقص عدد العائدين.. قد يعود البعض إلي "الرومدة" لأخذ بعض الأشياء، ومن ثم العودة الي المكان الذي جاءه أصلا للبحث فقط عن الكلأ.. وتنقطع في النهاية العلاقة بالحي المركزي لان الكلأ فيه غير كاف للقطعان.. ولا يبقي من كل ذلك سوي أبيات من النسب أو الغزل، أي ما لا يكفي للمساهمة في التنمية البشرية.
مشكلتنا نحن الموريتانيين أن معاييرنا وثوابتنا بدوية تماما كما نحن بداة، فهي تنتقل معنا ولا تدور معنا.. وهو ما لا يساعدنا في أن نحدد موقعنا في عالم يدور حول نفسه ويدور أيضا داخل نفسه.
فقد تعودنا طوال القرون الماضية أن ننتقل حاملين موريتانيا في رؤوسنا، ننتقل بها في قلوبنا وتحل معنا حيث ما حللنا.. إذن، لم نكن محتاجين إلي ان نكون فيها أو نذهب إليها.. إلا أن هذا النوع من التواجد لم يعد كافيا حتى الآن لبناء الأمم.
جريدة "القلم"
سنة 2000
.jpg)