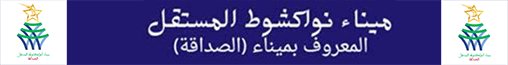تقديم:
تدخل موريتانيا اليوم مرحلة جديدة في علاقتها بواحدة من أعقد التحولات الاجتماعية والسياسية في فضائها الإقليمي: الهجرة. فلم تعد الظاهرة مسألة عابرة أو حركة بشرية مؤقتة، بل تحوّلت بفعل عوامل بنيوية وضغوط إقليمية إلى تحدٍّ وطني يمسّ صميم قدرة الدولة على التنظيم والضبط وحماية توازناتها الداخلية.
وبين انهيار المنظومات الأمنية في الساحل، وضعف بعض الدول المجاورة، وبروز موريتانيا كمنطقة استقرار نسبي، تكدّس داخل المدن الموريتانية حضور بشري كثيف خارج أي نظام قانوني أو إحصائي.
ولأن الدول تُختَبَر دائمًا عند حدود قدرتها على إدارة الفوضى، فقد وجدت موريتانيا نفسها أمام سؤال جوهري: كيف تتحوّل من التسامح التقليدي إلى الضبط الجمهوري؟ وكيف تُعيد إمساك زمام مجالها البشري باستخدام أدوات القانون، والمعطيات، والرؤية الاستراتيجية؟
أولًا: لماذا أصبحت الهجرة إلى موريتانيا تحديًا بنيويًا؟
منذ العقد الأخير، تحوّلت موريتانيا من بلد عبور إلى بلد استقرار بالنسبة لآلاف الشباب من غرب إفريقيا. والأسباب بنيوية تتمثل في:
تدهور الأوضاع الأمنية في الساحل
إذ يشهد هذا الفضاء توسعًا لنفوذ الجماعات المسلحة واشتداد التنافس بين الفصائل المحلية، ما خلق فراغات أمنية واسعة. وقد أدّى انسحاب القوات الدولية وتراجع قدرات الجيوش الوطنية إلى تفاقم هشاشة المنطقة بشكل غير مسبوق.
انهيار بعض الدول أو ضعفها (مالي، بوركينا فاسو، النيجر وغيرها…)
تعاني هذه الدول من أزمات سياسية متكررة ونكسات مؤسساتية جعلت الدولة عاجزة عن بسط سلطتها على كامل التراب الوطني. كما أسهمت الانقلابات، وتغيّر التحالفات الدولية، وتدهور الاقتصاد في تقويض شرعية الحكومات وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
موقع موريتانيا كمنطقة استقرار نسبي
برزت موريتانيا كجزيرة استقرار نسبي بفضل سياسة أمنية تجمع بين الحزم العسكري والانفتاح على الحوار المجتمعي والديني. كما ساعدها نهج "الحذر الاستراتيجي" في تجنّب تداعيات الانهيارات الإقليمية ومحاصرة التهديدات عبر الحدود.
اقتصاد خدمات مفتوح
يعتمد الاقتصاد الموريتاني بدرجة متزايدة على الخدمات مثل النقل، واللوجستيات، والاتصالات، ما جعله مرنًا أمام تقلبات بعض القطاعات التقليدية. هذا الانفتاح خلق فرصًا للاستثمار الإقليمي، لكنه في الوقت نفسه زاد من حساسيته للتقلبات الخارجية.
شبكات التجارة والطرق العابرة للصحراء
تشكّل الطرق القديمة العابرة للصحراء شرايين اقتصادية واجتماعية تربط موريتانيا بمحيطها الغربي والساحلي. ولا تزال هذه الشبكات تُستخدم في نقل البضائع والماشية، وكذلك في حركة الأشخاص، ما يجعلها عنصرًا حيويًا في ترابط الأسواق المحلية والإقليمية.
سهولة الحركة عبر الحدود مع مالي والسنغال
رغم وجود نقاط مراقبة، تبقى الحدود مع مالي والسنغال مفتوحة نسبيًا بحكم البنية الجغرافية وترابط المجتمعات المحلية على جانبي الحدود. هذه السهولة تعزّز التبادل التجاري والاجتماعي، لكنها تفتح كذلك المجال لتحركات غير نظامية تحتاج إلى إدارة دقيقة.
كل هذه المعطيات صنعت ظاهرة جديدة وهي وجود كتلة بشرية كبيرة داخل المدن الموريتانية، خارج أي نظام إقامة، خارج الإحصاء، وخارج رقابة الدولة. ولا شك أن هذا، لا يغيب عن الدولة، إلا أنه هو أخطر ما يمكن أن تتعامل معه دولة صغيرة ات موارد محدودة مثل موريتانيا.
ومع تراكم هذه العوامل البنيوية، برزت داخل المدن الموريتانية ديناميات جديدة تحمل في طياتها تحديات عميقة للدولة وإدارتها للفضاء الوطني. فأول ما يظهر هو الفراغ الإحصائي الناتج عن وجود عشرات الآلاف من المقيمين غير المسجّلين، ما يجعل الدولة عاجزة عن تقدير حجمهم، بنيتهم، أو احتياجاتهم. ويُنتج هذا بدوره حركة سكانية غير مرئية تتحرك بين الأحياء والمدن دون مسارٍ قابل للرصد، فتتكون شبكات داخلية يصعب إدماجها في التخطيط العمراني والاجتماعي. كما ينمو حول هذه المجموعات اقتصاد غير رسمي يقوم على خدمات يومية متناثرة وورش صغيرة وحرف آنية خارج الرقابة الضريبية والبلدية، وهو اقتصاد يوفر لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين فرص البقاء لكنه يحرم الدولة من أدوات التنظيم والجباية.
ويُضاف إلى ذلك مخاطر أمنية محتملة، ليس بالضرورة من حيث الجريمة المنظمة، ولكن من حيث صعوبة معرفة من يوجد داخل البلاد وما هي خلفياته ومسارات تحركه؛ وهو ما يُولّد بدوره هشاشة في الضبط تجعل قدرة أجهزة الأمن والإدارة على إدارة المجال الحضري أكثر تعقيدًا. وإلى جانب كل ذلك، تفرض هذه الكتلة المتزايدة ضغطًا على الخدمات الأساسية كالماء، والصحة، والنقل، والطرق، مما يضع المدن - وخاصة نواكشوط ونواذيبو - أمام واقع ديموغرافي جديد لم تُصمّم بنيتها لاستيعابه. هكذا تتداخل العوامل البنيوية مع هذه الديناميات الخطرة لتجعل الهجرة إلى موريتانيا تحديًا مركّبًا لا يقتصر على الإقامة وحدها، بل يمتد إلى صميم قدرة الدولة على التوقع، والإدارة، والضبط.
هذه العوامل البنيوية وما انضاف إليها من ديناميات جديدة جعل موريتانيا أمام الاختبار الحقيقي: هل تستطيع موريتانيا "تحويل الكمّ غير المرئي" إلى "سكان مرئيين" عبر القانون؟
ثانيا: من الفوضى إلى المعايير: إصلاح سياسة الهجرة إلى موريتانيا
منذ منتصف عام 2022 دخلت الدولة الموريتانية مرحلة جديدة من إدارتها لملف الهجرة، بعد سنوات طويلة ظل هذا المجال يتحرك خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي مستقر. ولأول مرة تتجه الدولة نحو بناء إستراتيجية وطنية شاملة تتعامل مع الظاهرة بوصفها تحديًا بنيويًا يتقاطع فيه الأمني بالقانوني، والاجتماعي بالسيادي، وتستلزم معالجته رؤية متماسكة تتجاوز الحلول الظرفية. وقد جاء هذا التحول استجابة لحاجة الدولة إلى ضبط الفضاء الداخلي، وصيانة توازناتها، وتنظيم الوجود الأجنبي بما ينسجم مع معايير الدولة الحديثة.
لم يكن هذا التوجه الأمني والتنظيمي منبتًّا عن محيطه الإفريقي، بل جاء في انسجام كامل مع خصوصية العلاقة التي تربط موريتانيا بجوارها وجاليات القارة التي استقرت داخل حدودها عبر عقود. لذلك حرصت الدولة على صياغة مقاربة تجمع بين صرامة القانون ورحابة الأخوة الإفريقية، عبر مكافحة الهجرة غير النظامية دون المساس بروابط القربى، ولا بروح الانفتاح التاريخي التي طبعت الشخصية الموريتانية. إنها مقاربة تحاول أن توازن بين ضرورات السيادة وواجبات الجوار، بين مقتضيات الأمن ومتانة العلاقات الإنسانية.
وقد تجسدت هذه الرؤية في سلسلة محاور عملية شكّلت العمود الفقري للإستراتيجية الجديدة: تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بشكل شامل وغير مسبوق؛ فتح عشرات نقاط العبور لتنظيم حركة الوافدين؛ إلغاء التأشيرة التقليدية لصالح نظام إلكتروني حديث يضمن الشفافية والفاعلية؛ مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار لضبط الحركة عبر الحدود؛ ثم الشروع في تحيين قانون الهجرة بما يتلاءم مع العصر ومع التحديات الأمنية والتنموية المتجددة. وبهذه الخطوات المترابطة، بدأت موريتانيا تنتقل من إدارة الهجرة كأمر واقع إلى التعامل معها كسياسة دولة ذات رؤية، تراعي الأمن وتُصون الكرامة وتُحافظ على روابط القربى الإفريقية.
ثالثا: التحوّل من "التسامح التقليدي" إلى "الضبط الجمهوري"
هنا لا بد أن نذكر تعاطي وزارة الداخلية مع هذا الملف فقد تحولت في تعاطيها معه من مجرد بنية تدير الشأن اليومي إلى مؤسسة ضبط سكاني (Population Management) بالمعنى الحديث.
وهذا يعني أنه في مواجهة هذه التحولات، تبرز الحاجة إلى وضع نظام إقامة شفاف يتيح للدولة معرفة من يدخل البلاد ومن يقيم فيها، ويمنح المقيم نفسه إطارًا واضحًا يضمن حقوقه ويحدد وضعه القانوني دون التباس. ويتكامل هذا مع تحديد حقوق المقيم في العمل، والسكن، والتنقل، والاستفادة من بعض الخدمات الأساسية بما يرسّخ شعورًا بالاستقرار والاحترام المتبادل.
وفي المقابل، لا بد من تحديد واجباته القانونية والإدارية، مثل احترام القوانين المحلية، وتجديد الإقامة، والالتزام بضوابط العمل، حتى يصبح وجوده جزءًا من النسق المؤسسي لا خارجه.
ولتحقيق ذلك، يُعد توثيق بياناته خطوة حاسمة، إذ تمنح الدولة قاعدة معرفية دقيقة تُسهّل التخطيط الأمني والاجتماعي. كما يسمح هذا الإطار بضبط تحركاته داخل البلاد عبر آليات متدرجة تحترم حرية التنقل لكنها تمنع الغموض وتحدّ من المخاطر المحتملة.
وفي النهاية، فإن الغاية من كل هذه المحددات هي ضمان أمنه وأمن البلد معًا، عبر صياغة علاقة قانونية وإنسانية توازن بين احتياجات المقيم ومتطلبات الدولة، وتنتقل بالهجرة من حالة الفوضى غير المرئية إلى حالة تنظيم رشيد ومستقر.
وباختصار فهذا هو المبدأ الجمهوري القائم على شعار: لا طرد، ولا فوضى.. بل تقنين.
على أن الإحصاء الشامل للوافدين يشكل خطوة مفصلية، فهي المرة الأولى التي تعرف فيها موريتانيا على وجه الدقة من يعيش داخل حدودها، وهو مكسب سيادي بالغ القيمة يعيد للدولة قدرتها على الرؤية والتقدير.
ومن هذا الأساس، جرى تحويل الهجرة من مجرد "ظاهرة" متروكة للتقديرات والانطباعات إلى "ملف دولة" يُدار بعقل استراتيجي، حيث ظهر الطاقم المسؤول عن ملف الهجرة لا بوصفه بنية إدارية فحسب بل بوصفه يقدم رؤية دولة تعيد ترتيب علاقة البلاد بمحيطها البشري. وبموازاة ذلك، تشكّلت علاقة قانونية واضحة بين الدولة والمقيم، لم تعد محكومة بالمزاج أو الأعراف العابرة، بل بإطار حديث يربط بين "دولة مسؤولة" و"فرد له وضع قانوني"، وهو ما يُرسّخ أسس الشرعية المؤسسية في بلد يسعى إلى ضبط فضائه الداخلي بثقة ورؤية.
رابعا: لماذا هذا التحول مهم سياسيًا؟
إن موريتانيا دولة محدودة سكانيًا (بسبب قلة السكان)، ومقيدة اقتصاديًا (بسبب سوق غير رسمي واسع)، وممتدة أمنيًا (بسبب الحدود الطويلة)، ولذلك فإن أي تدفق بشري غير منظم يمكن أن يغيّر التوازنات السكانية بسرعة تفوق قدرة الدولة على الاستيعاب. كما أنه يخلق اقتصاد ظلّ يتنامى على هامش القانون ويصعب ضبط مساراته، ويفتح الباب للجريمة العابرة بما تحمله من شبكات وحركات لا تعترف بالحدود. ومع اتساع هذه الظواهر، تُصاب الإدارة بالارتباك نتيجة ضعف المعطيات وصعوبة المتابعة، فيما تتعرض المدن لضغط عمراني وخدماتي يتجاوز بنيتها الأساسية. وفي النهاية، يمتد الأثر إلى السلم الاجتماعي ذاته، إذ تتحرك المجتمعات في فضاء يتطلب يقظة مؤسساتية تضمن التوازن وتحمي الاستقرار. وبالتالي فإن ضبط الهجرة ليس عملًا إداريًا، بل سياسة سيادية.
خامسا: النجاحات: أين أصابت الدولة في تسييرها ملف الهجرة؟
لقد أدخلت وزارة الداخلية - وفق رؤية واضحة - منطق الدولة الحديثة إلى ملف ظلّ لعقود خارج دائرة اللمس، فحوّلته من هامش مائع إلى مجال سيادي منضبط. وهذا وحده يجعله أقرب في أثره إلى القرارات الكبرى التي طبعت الدولة الموريتانية في السبعينات كتأميم "ميفرما" وإنشاء "الأوقية" وغيرها من القرارات السيادة التي عرفتها دولتنا الفتية؛ لأن ما فعلته الوزارة ليس مجرد إجراء إداري، بل إعادة تعريف لسلطة الدولة على مجالها البشري.
وبفضل هذا التحول، تقلّص هامش الفوضى واتسعت مساحة الوضوح؛ إذ تحوّل آلاف المقيمين من "مجهولين" يعيشون خارج أي إطار إلى "أفراد معلومين" في قاعدة بيانات سيادية تمكّن الدولة من التخطيط والمعرفة والرؤية.
وفي الوقت نفسه، نجحت الوزارة في طمأنة الداخل والخارج معًا؛ فأرسلت للدول المجاورة وللشركاء الأوروبيين رسالة واضحة مفادها أن موريتانيا ليست فراغًا ولا نقطة عبور سائبة، بل دولة تملك إرادة تنظيمية حقيقية. وربطت الوزارة - وهذا هو التحول الأعمق - بين الأمن والشرعية القانونية، فانتقلت الدولة من الاعتماد على أدوات الضبط التقليدي إلى منطق التنظيم الحديث الذي يُشرك القانون والمعطيات والمؤسسات. وبهذا عادت لوزارة الداخلية صورتها الأصلية: "وزارة دولة" تتصرف بمنطق السيادة، لا مجرد جهاز ضبط يومي، مما عزّز الثقة في مؤسساتها ورفع منسوب حضورها وهيبتها داخل المشهد الوطني.
لم تكن الأجهزة المكلفة بملف الهجرة بصدد أداء وظيفة روتينية أو القيام بإصلاح إداري عابر؛ لقد تحرّكت بمنطق الدولة لا بمنطق الإدارة، وبذهنية من يفكّر في هندسة المستقبل لا في إطفاء حرائق الحاضر. وكان من الواضع أن وزارة الداخلية في هذا السياق عملت على المدى البعيد، وأعادت ترتيب ملف استراتيجي ظلّ في الهامش سنوات طويلة، وكأن الجميع سلّم بأنه غير قابل للمسّ. ومع ذلك، كان العمل كله يتم بصمت وثبات، بلا ضجيج إعلامي ولا بحث عن أضواء، مما أدخل موريتانيا - بخطوات محسوبة - إلى منطق القانون بدل منطق العادة، وإلى فضاء التنظيم الحديث بدل الارتجال التقليدي.
وفي علم السياسة ما يُسمّى "صناعة الدولة" (L’art de gouverner) ويعني بناء قدرة الدولة على الفعل والرؤية وضبط المجال. وهو مقام نادر في عالمينا العربي والإفريقي؛ لأن بلوغه يحتاج إلى عقل استراتيجي، وصلابة في القرار، ونَفَس طويل لا ينظر إلى الغد القريب فقط، بل إلى ما بعد الغد.
سادسا: التحديات: ماذا يَنْتَظِرُ موريتانيا؟
تظلّ أبرز التحديات التي تواجه موريتانيا في هذا الملف مرتبطة بالحضور الميداني، فالقوة في القرار لا تكفي ما لم تدعمها قوة في التنفيذ، وموريتانيا بلد واسع الأطراف قليل الموارد، ما يجعل ضبط الحدود ومراقبة الحركة البشرية عملًا يفوق في تعقيده إمكانات دولة صغيرة.
كما يتشابك ملف الهجرة مع اقتصاد غير رسمي يُعدّ شريانًا حيويًا في نواكشوط ونواذيبو والزويرات وغيرها من المدن الداخلية، حيث يدير المهاجرون نسبة معتبرة من الأنشطة اليومية، وهو ما يجعل تنظيم هذا المجال مسألة دقيقة تحتاج تدرّجًا لا يصطدم بالواقع ولا يدمّر مصادر أرزاق الناس.
وإلى جانب ذلك، يبقى هاجس الاحتكاك الاجتماعي حاضرًا بقوة؛ فتنظيم الوجود الأجنبي يخضع دائمًا لحساسية شعبية، ويحتاج مقاربة توازن بين السيادة واحترام النسيج الاجتماعي. ثم تأتي الحاجة إلى "دولة خدمات" قادرة على مواكبة التنظيم؛ فحين تفرض الدولة قواعد الإقامة وتضبط حركة الوافدين، فإن عليها في المقابل تقديم حدّ أدنى من الخدمات يضمن الكرامة ويمنح النظام شرعيته. وبدون هذا التوازن الدقيق بين الضبط والرعاية، يفقد التنظيم روحه ويتحوّل من مشروع دولة حديثة إلى عبء إداري لا يحقق الغاية المرجوة.
خاتمة:
إن ما قامت به موريتانيا خلال السنوات الأخيرة ليس مجرد تنظيم للإقامة، ولا مجرّد ضبط لحركة الوافدين، بل هو بداية انتقال حقيقي نحو بناء دولة حديثة تُدير فضاءها البشري بعقل استراتيجي لا بردود الفعل. وقد أثبتت التجربة التي وقفت وراء ملف الهجرة أن الدولة حين تتقدّم بخطاب القانون بدل العادة، وبمنطق الدولة بدل منطق الإدارة، يمكنها أن تغيّر مسار ملف ظلّ عصيًا على التنظيم لسنوات طويلة. ومع ذلك، فإن الطريق ما يزال طويلًا، فالتحديات الميدانية، وتشابك الهجرة مع الاقتصاد غير الرسمي، واحتمالات الاحتكاك الاجتماعي، كلها عوامل ستختبر قدرة الدولة على الاستمرار في هذا النهج. لكنّ المؤكد أن موريتانيا وضعت قدمها على الطريق الصحيح: طريق تحويل "السكان غير المرئيين" إلى "فاعلين مرئيين" داخل نظام قانوني واضح، وتثبيت سيادتها على مجالها الإنساني، وصياغة نموذج جديد للهجرة يجمع بين الإنسانية والتنظيم، وبين الأمن والشرعية، وبين الرؤية والقدرة. بهذه الروح وحدها تستطيع الدولة أن تواجه المستقبل بثقة.
.jpg)